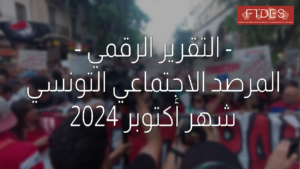الأبوية المفرطة في دستور قيس سعيّد
محمد رامي عبد مولاى
يحس الكثير من التونسيين بحالة من “اليتم” السياسي منذ سنوات مفسرين تأزم أوضاعهم الاجتماعية-الاقتصادية و”فوضى” المشهد السياسي بغياب رئيس قوي ينهي حالة “العبث” ويتخذ القرارات “الصحيحة” بحزم وسرعة دون خوف من الأحزاب والنقابات ومختلف مكونات المجتمع المدني. وسيتفاقم هذا “اليتم” مع إفرازات تشريعيات 2019 وفداحة الخسائر البشرية التي خلفتها الأزمة الوبائية خاصة في ربيع/صيف 2021. ما أعلنه قيس سعيّد من قرارات يوم 25 جويلية 2021 جعل منه “مبعوث العناية الإلهية” في عيون الكثير من التونسيين، وحتى “الأب الضال” الذي يفتقدونه. اليوم ومع إعلان مشروع الدستور الذي سيستفتى فيه التونسيون يوم 25 جويلية 2022، يبدو أن قيس سعيّد يسعى لدسترة هذه “الأبوة”. المشكلة أنه كلما تقدمنا عبر أبواب النص المقترح ودروبه يتكون لدينا انطباع قوي بأننا إزاء مشروع “أبوة” امتيازات سلطوية (صلاحيات رئيس الجمهورية) لا “أبوة” واجبات (السياسات والحقوق الاجتماعية-الاقتصادية).
- الأب المنقذ والمصلح والمؤسس
يندر أن نجد توطئة دستور شخصية ومشخصنة مثل الواردة في مشروع دستور رئيس الجمهورية. تكاد تقرأ “نحن قيس سعيد” بدلا من “نحن الشعب التونسي” وتكاد تسمع “نحن الحبيب بورقيبة” الواردة في توطئة دستور 1959. وإن كان بورقيبة يستند إلى “الشرعية” التاريخية والنضالية باعتباره زعيما سياسيا وقائدا للحركة الوطنية ضد الاستعمار ومؤسسا للجمهورية، فإنّ تاريخ قيس سعيد و”نضالاته” لا يمنحانه مثل هذه الشرعية. ما العمل؟ استجلاب شرعية خاصة به و/أو الانتساب إلى شرعيات الآخرين. أولا، شرعية “المخلص” الذي حركه “الشعور العميق بالمسؤولية التّاريخية” ليتحرك يوم 25 جويلية 2021 (ذكرى تأسيس الجمهورية التونسية على يد الحبيب بورقيبة) فهب ل”تصحيح مسار الثورة” بل و”تصحيح مسار التاريخ”.. وهكذا أنقذ “صانع التغيير” الشعب التونسي الذي صبر وصابر لمدة أكثر من عقد من الزمن”، وأنقذ “الثورة المباركة”، و”الجمهورية”. ثانيا، شرعية المؤسس، فالنص الذي يعرضه قيس سعيّد على الاستفتاء “يؤسس نظاما دستوريا جديدا” لم يأت من فراغ بل هو استكمال لل”انفجار الثوري في 17 ديسمبر 2010″ وتتويج لحركة التّصحيح التي انطلقت ب”مناسبة الذّكرى الرابعة والستّين لإعلان الجمهورية” (سنة 2020 مع تولي قيس سعيد الرئاسة).. وما بين ديسمبر 2010 ومارس 2020 خلاء وقفار. ثالثا، شرعية رجل الدولة/المصلح، فحسب التوطئة يتنزل الدستور الذي يقترحه الرئيس في استمرارية ل “تراثنا الدستوري الضارب في أعماق التّاريخ من دستور قرطاج إلى عهد الأمان، إلى إعلان حقوق الراعي والرعية وقانون الدولة التّونسية لسنة 1861، فضلا عن النّصوص الدستورية التي عرفتها تونس إثر الاستقلال”.
- الأب القوي الحازم
“الدستور الحقيقي هو الذي خطّه الشباب على الجدران”، هذا ما قاله قيس سعيّد ذات اليوم، ولكن عندما نطلع على مشروع الدستور الجديد نجد أن كلمة “الشباب” لم تستعمل إلا مرة واحدة (الفصل 13) في حين حضرت عبارة “رئيس الجمهورية” قرابة الستين مرة. وهذا التنكّر للشباب، على الرغم من دوره المركزي في ثورة 2011 وحتى في وصول رجل بلا تاريخ نضالي/سياسي مثل قيس سعيّد إلى قصر قرطاج، ليس بالأمر المستغرب فهذا الرجل “المحافظ” -وجيله- نتاج لأنظمة بطريركية، وحتى وإن حاول التأقلم مع “متغيرات العصر” فأقصى ما يمكنه فعله هو إنتاج نظام أبوي مخفف وأقل قسوة.
“المزاج الشعبي” أيضا ليس متحمسا للشباب ولا للتشاركية ولا لقواعد “اللعبة السياسية الديمقراطية”.. كثيرون يطالبون برجل قوي ينهي “عبث” منظومة الحكم التي انبثقت عن “مسار الانتقال الديمقراطي”.. كثيرون يبحثون عن “أب” يرحمهم من “أزواج” الأم الذين تعاقبوا عليهم منذ سنوات، كما يعبّر عن ذلك المثل الشعبي التونسي. فالانتقال المباغت من نظام رئاسي صلب وديكتاتوري إلى نظام “مائع” وهجين يشبه البرلماني دون أن يكون كذلك، لم يلق استحسان الكثير من التونسيين خاصة الأكبر سنا، وتعمق هذا الرفض ليصبح كراهية صريحة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية/الاجتماعية والأمنية بعد 2011. جزء هام من التونسيين يرى أن “تشتيت” السلطة بين أيدي أكثر من ربان أضاع اتجاه السفينة وسينتهي بإغراقها، وأن عودة نظام رئاسي صريح هو الحل الوحيد لإنقاذ “الشقف”.
مثل انتخاب الباجي قايد السبسي رئيسا للجمهورية في 2014 خطوة في هذا الاتجاه باعتباره رجلا “محنكا” قادما من “الزمن الجميل” للرؤساء المهيبين الأشداء وليس “طرطورا” خاضعا للأحزاب الحاكمة، لكن “البجبوج” كما كان يسميه الكثير من التونسيين ظهر في مظهر “جدّ” هرم لم يستطع التصدي للذئاب الهرمة والشابة المتربصة بالسلطة والدولة في آخر سنوات حياته السياسية والبيولوجية. وفي أوج الأزمة السياسية والوبائية التي كانت البلاد تعيشها في صيف 2021 كان هناك مزاج شعبي ساخط على الحكومة والبرلمان وكل “المنظومة” التي أنتجها “الانتقال الديمقراطي”.. فجاء قيس سعيّد وقطف عناقيد الغضب ثم عصرها في دستوره خمرا رئاسيا معتّقا.
لم يكتف كاتب الدستور المطروح للاستفتاء بتقزيم السلطة التشريعية (عبر سحب تعيين رئيس الحكومة ومساءلة الحكومة منها وإضافتهما إلى صلاحيات رئيس الجمهورية) بل عمل على تشتيتها بإضافة غرفة برلمانية ثانية “تزاحم” مجلس نواب الشعب في عدة صلاحيات: المجلس الوطني للجهات والأقاليم. أما التعامل مع القضاء فكان أكثر ذكاء: الإبقاء على امتيازات القضاة مع إطلاق يد السلطة التنفيذية أكثر في تنظيم السلطة القضائية (وبالتالي التحكم فيها). السلطة التنفيذية لم يعد لديها رأسان (رئيس جمهورية محدود الصلاحيات ورئيس حكومة قوي مسنود برلمانيا) كما كان الأمر في دستور 2014 بل رأس واحد هو رئيس الجمهورية. واذا ما تمت المصادقة على الدستور المقترح فإننا سنعود إلى أجواء حكومات بن علي: وزراء أول تابعون تماما لرئيس الجمهورية يقودون حكومات باهتة. ويبدو أن رئيس الجمهورية أراد تهيئتنا للمشهد الجديد عبر إصدار المرسوم 117 لسنة 2021 وتعيين حكومة نجلاء بودن. وهكذا سيصبح لدينا رئيس جمهورية قائد أعلى للقوات المسلحة يحتكر السلطة التنفيذية ويسمي القضاة ويمكنه حل مجلس نواب الشعب؛ أب مكتمل الصلاحيات والقوة. ويقترح هذا الدستور الناضح أبوية الترفيع في السن الدنيا الضرورية للترشح إلى رئاسة الجمهورية: من 35 سنة (دستور 2014) إلى 40 سنة.
- جدل حول الدستور والاقتصاد الوجه والقفا
قد يتحجج البعض بأن الدساتير لم تجعل لتضمين مبادئ وسياسات اقتصادية/اجتماعية مفصلة وثابتة فالدستور يرسم الخطوط العريضة والاقتصاد ديناميكي ومتحول بطبعه. يمكن أن تكون لهذا الكلام بعض الوجاهة لو أن الدستور الذي نتحدث عنه أتى في سياق مختلف ومن صلب أب آخر. فلقد أراده سعيد دستورا مصححا لمسار التاريخ ومؤسسا لجمهورية جديدة ووعاء لبرنامجه السياسي الشخصي. وكما بيّنا ذلك سابقا فإن مشروع الدستور هذا أبوي مفرط في الأبوية، وبما أنه يمنح للرئيس الأب صلاحيات وسلطات واسعة جدا -وصفها وعددها بالتفصيل- تجعله في مرتبة نصف إله فمن الطبيعي أن نتساءل عن واجبات “الرعاية” وحقوق “العيال”.
تضمنت الاستشارة الوطنية (أولى محطات “خارطة الطريق” التي أعلنها قيس سعيّد وأجريت عن بعد خلال الفترة الممتدة من 14 جانفي إلى 20 مارس 2022) جملة من المحاور والأسئلة ذات الطابع الاقتصادي-الاجتماعي، كان يفترض أن تكون حاضرة عنصرا أساسيا في نقاشات “الحوار الوطني” وجلساته ومسودات الدستور المنبثقة عنها. وقبل أيام من نشر رئاسة الجمهورية لمشروع الدستور في 30 جوان 2022، كثر الحديث من قبل أعضاء في “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” عن دسترة السياسات الاقتصادية، وعلى رأسهم المنسق الصادق بلعيد الذي تحدث عن نهاية دولة الرعاية أو “التكيّة” كما أسماها والتحرير الكلي للمبادرة الاقتصادية (وهذا ما سيتأكد في النسخة التي سلمها لرئيس الجمهورية ثم نشرها في جريدة الصباح بتاريخ 03 جويلية 2022 ، والتي نجد فيها بابا مخصصا ل”أسس السياسة التنموية”). كما بشرنا الكثيرون من أنصار رئيس الجمهورية ومفسري أحاديثه في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بأن الدستور الجديد لن يكون “سياسويا” محضا بل سيتضمن توجهات اقتصادية جديدة. حتى توطئة مشروع الدستور المطروح للاستفتاء أعطتنا انطباعا بأن الشق الاقتصادي-الاجتماعي سيكون حاضرا بقوة في الدستور وأن ريح الثورة وروحها سيكتسحان النص: “التجويع والتنكيل في كل مرافق الحياة”، “مطالبه المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية”، “زاد الفساد استفحالا”، “الاستيلاء على ثرواتنا الطبيعية”، “السطو على المال العام دون محاسبة”، “مرحلة تحقيق العدالة”، “ديمقراطية اقتصادية اجتماعية”، “التوزيع العادل لثروات الوطن”، “التنمية الاقتصادية والاجتماعية”، “تنمية مستمرة دائمة”، الخ.
ومن الطبيعي أن تخلق هذه التوطئة “صعودا شاهقا غير مسبوق” في سقف التوقعات، لكن بالمرور إلى قراءة أبواب وفصول الدستور لا نجد صدى قويا لهذا “الانفجار الثوري”. فقد جاء حضور الحقوق الاقتصادية الاجتماعية باهتا ولم تفرد بباب خاص بها بل ضمنت أساسا في الباب الثاني مع بقية “الحقوق والحريات”. وهي تتلخص في بضعة فصول جد عمومية يمكن نسبتها إلى الجيل الثاني من حقوق الإنسان: تهيئة أسباب العيش الكريم (الفصل 22)، حرية تكوين النقابات والعمل النقابي والاضراب (الفصلين 40 و41)، حرية الاجتماع والتظاهر السلميين (الفصل 42)، الحق في الرعاية الصحية ومجانيتها لفاقدي السند وذوي الدخل المحدود، والضمان الاجتماعي بشروط (الفصل 43)، الحق في التعليم ومجانيته (الفصل 44)، الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل لكل مواطن ومواطنة (الفصل 46)، وحماية الفئات الأكثر هشاشة مثل المرأة (الفصل 51) والأطفال (الفصل 52) والمسنين فاقدي السند (الفصل 53) وذوي الإعاقة (الفصل54). وهناك فصول يمكن إدراجها ضمن حقوق الجيل الثالث من حقوق الإنسان (الحقوق البيئية والتنمية المستدامة وجودة الحياة) مثل الفصل 47: “تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي”، أو جامعة بين الجيلين مثل الفصل 48 “على الدولة توفير الماء الصالح للشراب للجميع على قدم المساواة، وعليها المحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة “. بالإضافة إلى الفصلين 16 و19 من باب الأحكام العامة، والمتعلقين بملكية الشعب للثروات الطبيعية وحقة في توزيع عادل ومنصف لعائداتها، والتنصيص على أن “الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة”. فضلا عن عمومية هذه الحقوق وضبابيتها فإنه سبق وأن تمت دسترتها في 2014 و/أو في 1959.
وليس الحال بأفضل فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية-الاجتماعية الكبرى للدولة وسياساتها التنموية “الجديدة”، لا نجد “إعلان نوايا” بخصوص تغييرات جذرية في “النموذج الاقتصادي” القائم. لا إعادة اعتبار للفلاحة ولا سعي لتكريس السيادة الغذائية، ولا حديث عن الصناعة ولا إشارة للاقتصاد الرقمي. كما لا نجد ذكرا للاقتصاد التضامني، فقط القطاعين العام والخاص وضمان “التعايش والتكامل بينهما” (الفصل 17) على الرغم من أن رئيس الجمهورية لم يفوت فرصة في السنوات الأخيرة للحديث عن “الشركات الأهلية” بل وأصدر مرسوما رئاسيا في الصدد (مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرّخ في 20 مارس). ما معنى التعايش والتكامل؟ هل يعني هذا مثلا عقد شراكات بينهما، أم تحديدا لمجالات كل واحد منهما. هل نفهم من خلال هذا الفصل أنه سيتم الحفاظ على مؤسسات قطاع العام من الخوصصة، أم العكس؟
كما تراجع دستور قيس سعيّد عن اللامركزية التي أقرها دستور 2014 في فصله الرابع عشر (“تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة”) واعتبرها أساسا للسلطة المحلية وخصها بأكثر من عشرة فصول (من الفصل 131 إلى الفصل 141)، فالنسخة المعروضة للاستفتاء لا تتضمن إلا فصلا واحدا (الفصل 133) في باب “الجماعات المحلية والجهوية” : تمـارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلّية المصالح المحلّيــة والجهوية حسبما يضبطه القانون”، هو فصل مستنسخ من الفصل 71 من دستور 1959 مع إضافة كلمة “الأقاليم” التي وردت في دستور 2014. وقد لا تكون اللامركزية علاجا سحريا لأمراض الاقتصاد التونسي لكنها لم تدخل حيز التنفيذ فعليا حتى نقيم التجربة، وإلغاؤها بجرّة قلم لا يطمئن حول مستقبل علاقة المركز بالجهات على الرغم من كل الكلام عن “الديمقراطية القاعدية” في خطاب قيس سعيد وأنصاره.
لا وجود في الدستور الجديد لمفهوم التمييز الإيجابي بشكل صريح، تتكرر عبارات “العدل” و”العدالة” و”الإنصاف” في عدة فصول لكن دون إقرار رسمي أو توضيح لسبل العدل والإنصاف، مثلا أن تكون “الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة” (الفصل التاسع عشر) أمر محمود وطلوب وضروري: لكن هل تشمل المساواة البعد والقرب الجغرافي من هذه الإدارات والمرافق وكثافة وجودها في كل ولاية؟ وعندما يتحدث كاتب الدستور عن التزام الدولة بحماية الموارد المائية وسلامة البيئة هل كان يقصد مثلا أنه سيتم التراجع عن الخيارات الكبرى في السياسة الفلاحية التونسية مثل الفلاحة التصديرية المستهلكة لكميات مهولة من المياه، والاستغلال والإنتاج المكثفين في الضيعات الفلاحية المتوسطة والكبرى؟ هل ستعدل الدولة سياساتها بخصوص الأنشطة الاستخراجية الطاقية والمنجمية؟ هل ستفرض قيود أكبر على مصانع النسيج والاسمنت والمجمعات الكيميائية؟
أما فيما يتعلق بمسألة التشغيل فالحلول الكبرى المقترحة في دستور سعيّد لا تقل “سحرية” عن الحلول التي تقترح و”تطبق” في العقدين الأخيرين: تشجيع العاطلين عن العمل على بعث المشاريع. لكن الدستور الجديد باعتباره امتدادا للانفجار الثوري أضاف إلى كلمة “مشاريع” صفة “تنموية” (الفصل 18). لكن لا بأس، حتى من عجز عن بعث مشروع فالدولة تضمن له حق العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.. كيف ذلك؟ الله أعلم. هل ستطلق مشاريع كبرى بتمويل عمومي متأت من قروض تعمق مديونيتها؟ هل ستعول على الاستثمارات الأجنبية؟ هل ستعول على الشركات التي سيبعثها رجال الأعمال الفاسدون المعنيون بمرسوم الصلح الجزائي (عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس)؟ هل ستأخذ من الأغنياء لتعطي للفقراء؟ هل ستنهي سياسة تجميد الانتداب في الوظيفية العمومية؟ هل ستقطع مع “مرونة” اليد العاملة والتشغيل الهش وأجور البؤس فتثير نفور رؤوس الأموال المحلية والأجنبية؟ هل ستتصدى للاقتصاد غير المهيكل أم ستواصل التعويل عليه لامتصاص البطالة والغضب؟
المقترحان الملموسان الوحيدان تقريبا في الشق الاقتصادي-الاجتماعي هما “المجلس الوطني للجهات والأقاليم” (الباب الثالث، القسم الثاني) و”المجلس الأعلى للتربية والتعليم” (الفصل 135)، الأول في علاقة بوضع السياسات والمخططات التنموية والثاني في علاقة بمسارات التعليم وآفاق التشغيل.
لا يبدو أن المسألة الاقتصادية-الاجتماعية تحتل موقعا متميزا في سلم أولويات رئيس الجمهورية، أو أنه لا يريد إغضاب أحد قبل إقرار دستوره وتدعيم أسس حكمه والشروع في تطبيق مشروعه السياسي. وتبدو المعادلة بسيطة في ذهن كاتب الدستور: سياسة جبائية قائمة على مبدئي “العدل والإنصاف” (الفصل 15)، ومكافحة الفساد، وإعطاء دور أكبر للجهات والأقاليم. وباعتباره أبا لا يفرق بين “أبنائه” الفقراء منهم والأغنياء (إلا العاقين منهم المعادون لمسار تصحيح التاريخ أو الفاسدون) يتحدث الرئيس عن السلم والعدل الاجتماعيين، وهما يتحققان حسب رأيه بالعدالة الضريبية والعدالة في توزيع الثروة، وفق نظرة/نظرية مثالية تركز على الحصى وتتغافل عن الصخور التي تسد سبل المساواة: التفاوت بين الجهات في حجم الثروة وخلقها، البنى التعليمية، موقع تونس في سوق العمل العالمي بما هي دولة طرفية غارقة في شراك المديونية و”اتفاقيات الشراكة” مع جهات أغنى وأقوى منها بكثير، هشاشة الاقتصاد التونسي، ضعف تنافسية المنتجات التونسية، ضرب طبقة صغار الفلاحين والسيادة الغذائية، غياب البنى التحتية وتردّيها، تحكم عائلات وطبقات في القرار الاقتصادي السياسي الخ.
غفل كاتب توطئة الدستور وهو يستعرض تاريخ(نا) ونضالات(نا) “نحن الشعب” عن ذكر محطات مهمة مثل جانفي 1978 وجانفي 1984 وجانفي 2008 لكن لا يجب عليه أن ينزعها من ذهنه: أب “لا يطعم من جوع” لن “يأمن من خوف” فحتى أكثر “الأبناء” برا بأبيهم قد يصيبهم “العقوق” عندما تنسد كل الأفق. ماذا سيفعل آنذاك وعلى من يعول؟ على القوة القمعية ؟ ربما ؟ خاصة وأنه ألغى تماما الفصل 19 من دستور 2014: الأمن الوطني أمن جمهوري، قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ”.
لا نعرف إن كان قيس سعيّد يدرك أم لا أن “الانتصار” المرجح لل”نعم” في الاستفتاء يعني أساسا رغبة جزء هام من التونسيين في معاقبة أحزاب ونخب أجهضت أحلامهم في العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة وجعلتهم يكفرون بال”ديمقراطية” و”الثورة” وينتظرون أي “مخلص” وأنهم في حال لم تتغير الأوضاع في المدى القصير والمتوسط فقد يكفرون ب”النبي” الجديد أيضا وقد يكون غضبهم وإحباطهم هذه المرة أشد. لكن في هذه الحالة هل سيتحول الغضب إلى تحركات ميدانية وحركات اجتماعية، هل سيجد من يتلقفه وينظمه ويجذره؟
اليوم، يبدو الفاعلون السياسيون والمدنيون المعنيون بالنضالات الاجتماعية-الاقتصادية في موقف صعب ومعقد. فهم مدعوون إلى تنظيم صفوفهم. فعلاوة على ضبابية المشروع السياسي والاقتصادي لرئيس الجمهورية، وتعاظم المؤشرات الدالة على سيره على خطى السابقين (المديونية، الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي و”الجهات المانحة”، السعي إلى تصفية القطاع العام، وتنصل الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية)، لن يكون من السهل التعامل مع الرئيس/الأب ذي الصلاحيات الواسعة خاصة إذا استمر في أوج شعبيته وشعبويته.